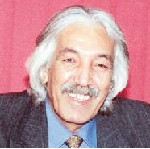تمت الاضافة إلى المفضلة
تم الاعجاب بالقصيدة
تم إلغاء الاعجاب بالقصيدة
لي سِتَةُ أشْباهٍ، مِثْلي
في الشّكلِ وفي اللونِ،
وقد وُلِدوا في البَرْقِ،
ويبكونَ مع الوردةِ في العيدِ،
ويرمونَ النارَ بأحْرُفِهم،
ويُحبّونَ الصّخبَ البرّيَ،
وكانوا مع زَهْرِ الليمونِ على سِلْسلةِ البحرِ،
وناموا مع غُزلانِ الكُحْلِ،
فقد ساحَت فوقَ سواعدِهم، ورأتْ
أنّ الجنّةَ في النارِ الباردةِ،
وفي الحَرْفِ المَهْموسِ..
وما وَقفوا للنَّهرِ! بل انغَمَسوا في ماءِ الحَرْفِ
وَحرْفِ الماء.
ولم يجدوا عُشبةَ جِلْجامِشَ،
قرأوا المِسْمارَ الطّينِيَ لتظهرَ بابلُ؛
كانت أشجارُ الأسماءِ المحفورةِ، ألواحُ العويذاتِ، الخَطّاءونَ، رثاءُ الحقلِ، مزاميرُ الدعواتِ، نوايا الجلّادينَ الفادِحةُ، وقوّةُ مَن عَجنوا الطّينَ الّلازِبَ، وغيابُ الرّوحِ، وظُلْمةُ أبوابِ القلعةِ في ساحاتِ الرَقْصِ الوحشيِّ أو العُريِ أو الهَوَسِ الجَمْعيِ.. هي الأرضُ المخفوقةُ بالطّاعونِ..
وبابلُ عمياء!
وما انتبهوا،
تاهوا..
انكسرتْ أحجارُ المَصْعوقِ،
انكفأوا في الأمْصارِ..
وغابتْ أعراسُ البَهْجةِ..
كانوا اللعنةَ وذيولَ الشيطانِ التائهِ،
أو قنديلَ الأغصانِ المُقْبِلَةِ،
وذرّاتِ هيولى الأزمانِ،
وكانوا الأرْحامَ العاقرةَ
بماءِ العِنّينِ المخذولِ،
وكانوا الأحياء.
جاءوا من غَفَواتِ النّارِ على الأحجارِ،
وقاموا مثل عفاريتِ العيدِ،
يبيعون الضحكةَ للأُنثى المجرورةِ
مع ألقاب الجَّدِ،
لتذهبَ، بعد الحَرْثِ، فتبذرُ
ما كان من القمحِ،
وتحْصدُ ما طالَ على السَفحِ،
وتُرضعُ سبعةَ أطفالٍ لم يجدوا غير النبعِ
المدعوكِ،
وتكبرُ،
لكنَّ الصّدرَ الطافحَ باللّبنِ يجفُّ،
فيعطشُ أطفالُ الحقلِ،
فيمضونَ إلى النبعِ الذهبيِّ..
وكانوا مثل الحَنّونِ الجبليِّ،
يُوَشِّحُ أثوابَ الأيامِ،
ويتركُ ما دَبّغَهُ الرُمّانُ على القمصانِ
البيضاء.
أولئك أشباهي الغزلانُ
الشُّعراءُ
العُشّاقُ
المذبوحونَ برمشِ الغانيةِ النجلاءِ،
التعساءُ
النبلاءُ
الأيتامُ
الأعلامُ
الأوّابون إلى النافذةِ العلياءِ،
النقباءُ
الأبرارُ
السُّمارُ
الأغيارُ
المرضى بالأرضِ وبالدارِ المحفورةِ
في العينِ الخضراء..
أولئك أشباهي الفتيانُ؛
ترنّقَ أوّلُهُم بالزّهرِ الباذخِ،
واسْتَرقَ الثاني وشوشةَ الوحيِ،
وذابَ الثالثُ في شَهدِ النارِ،
وعادَ الرابعُ من عُرْسِ البركانِ،
وقام الخامسُ يرقصُ في منديلِ النّهرِ،
وقالَ السادسُ ما أذْهلَ ساحِرةَ الكُهّانِ،
وما فتئ السابعُ ينبضُ
في كلِّ مرايا الشِّعرِ ليوضحَ
أسرارَ الأسماء.
أوَّلُهم مَن شَرِبَ الكأسَ،
وما عادَ إلى الوعيِ،
ولم تُسْكِرهُ الخمرةُ،
والثاني صَبَّ قليلاً
وتَلمَّظَ بغروبِ الشمسِ،
وأَسْلَمَ حالتَهُ لِلصَّحوِ المُترَنِّحِ،
أمّا الثالثُ لا يعرفُ للدَّنِّ مكاناً،
تاهَ.. وأَنْساهُ العقلُ دروبَ الشمسِ
وأين نهاياتُ الأضواءْ..
والرابعُ مَن قطفَ العنقودَ،
ولَمْلَمَ بعضَ الحَبَّاتِ
وأَودَعَها فَمَهُ، أو غَصَّ الشاربُ قبلَ الماءْ!
والخامسُ يجلسُ تحتَ الدّاليةِ
وينتظرُ الصيفَ على مَهَلٍ كي ينضجَ
عنقودُ الشّقراءْ!
والسادسُ ما زالَ بعيداً
يرقبُ أنْ يأتيَهُ الكَرْمُ
ويلقى الندمانَ الشُّعراءْ.
***
الأوّلُ ذاكَ المتكلّمُ،
ويكادُ الفَمُ أنْ يحترقَ من الأحْرفِ!
عيناهُ الحقلُ،
وغُرّتُه النّجْمُ،
وغَيمُ العاصفةِ على الرّأسِ،
وجَذْرُ التلّةِ في قدميهِ،
وكَفَّاهُ الّلامُ المكرورةُ والهاء.
ويَشْكُرُ آلآءَ النِعَمِ المستورةِ ،
ويُحِبُّ منازِلَهُ المنثورةَ،
والعُشْبُ لسانُ التَسْبيحِ،
ويأكلُ ما يصطادُ،
ويجْمعُ أعدادَ الأحرفِ فتفيضُ
الرّاءُ مع الباء.
ولا يتحدّثُ للناسِ،
وما كان برأسينِ..
الطائِرُ في السِّرِّ،
ويسعى لبلوغِ الإشْراقِ،
له المِحرابُ إلى السّينِ،
يُصلّي خلفَ الواقفِ،
بين النورِ وبين الليلِ،
وأوّلُ ما يعرفه النونُ،
ليخرجَ فاءً قبل الحاء.
يُسَلِّمُ بالكَفِّ ويومئُ للغُصْنِ
فيهتزُّ الصوتُ،
وَيْنَدهُ لِلسَّرْجِ
فيَزْجُرُهُ المَوْتُ،
ويرسمُ في الصَّمتِ
فيتبعُهُ البيتُ،
وما حارَ وما غارَ،
ولا لَفَّ ولا مارَ،
ولا ينطقُ بالسّوءِ،
سواءً في الذّْبْحِ أو الغَارِ،
هو الرّقراقُ التوّاقُ،
الماشي في الأحداقِ
إلى البَكّاءِ،
له الإخلاصُ الأصفى
من لَهَبِ العينينِ
إذا ما رَقَّ العاشقُ بالماءِ المحروقِ
من الجَفْنِ المَسْهودِ، من الإفْلاقِ،
وكيفَ لهُ أنْ يُطْرِقَ في الّلاشيءِ..
وفيهِ مِن الطفلِ صفاءُ البرقوقِ،
أو القولُ مِن التَّسْليمِ الحاسمِ بالخالقِ،
مثل عجوزٍ لا يكسِرُها الشّكُ،
ضياعاً،
في أرضِ الفُسّاقِ.
هو الحَكّاءُ الأبْكمُ
والرائي الأعمى
والساخِطُ من لونِ الحِرباءِ،
الرّاضي المَرْضِيُّ
ابنُ الأَمَةِ البكماءِ العمياءِ الخرساء.
والثاني في أرضٍ أُخرى،
تَفْضَحُهُ الزّهرةُ،
يُعطي الغاباتِ حكايَتَها المسْحورةَ،
فَيرى غَيْمَ رواياتِ الليلِ وحوشاً
من أَلَمٍ..
يَفْزَعُ،
يَهْلَعُ،
يبكي السَّبْعَ وأجنحةَ الصَقْرِ،
وآثارَ السَيّرِ على الموجِ،
وجَمْرَ الصيّفِ المتوهّجِ في الرِّيقِ الّلاذعِ،
يشربُ حدَّ الزّوغانِ، ويكتبُ بالسّيفِ
على الرّمْلِ قصائِدَهُ المكرورةَ،
ويثوبُ، مع الصُّبحِ، إلى النَمْلِ الأسْوَدِ،
يصطادُ فرائِسَهُ الصعبةَ في العَوْسَجِ،
ويرى الظمآنينَ فيَقْتُلهُ النَبْعُ
وَحَرُّ الظّاء .
ولا يأكلُ إلاّ ما يأتيه مِن السَّهْمِ،
ويُطْلقُ عينيهِ طيوراً تتحدّث كالياءِ،
وينعفُ من شفتيهِ النّحْلَ،
ويلعبُ بالحَيَّاتِ الدّهريةِ،
ويقول: الطالبُ للدنيا امرأةٌ تأكلها الشهواتُ.. وتحلمُ بالذّروةِ
حين ترى الفتيانَ الممشوقينَ كَحَرْفٍ
لم تَنْطِقهُ الألسنُ، إلا
حينَ يَجِنُّ الليلُ على الأشياء.
ينادى يا سيّدةَ الجَنّةِ!
كيف أراكِ بنومي
لأُتمّمَ ما وَسْوَسَهُ الشيطانُ لآدمَ؟
وتكونُ التفاحةُ مرآةَ العُريِ،
وأخْصِفُ مِن ورقِ الأشجارِ
ستائرَ حِشْمَتيَ المنهوبةَ،
وأعودُ إلى الأرضِ ليقتلَني الحَسَدُ،
وتهجرَني الصادُ الصخريةُ،
وتكون الخاء!
هو الإيجازُ الصعبُ
الغامضُ،
والرّافضُ للقَدَرِ البشريّ،
ويُعطي الأبراجَ ملاعِبَها،
لا يستفتي إلاّ ما قَرَّ ونامَ،
ويضحكُ ممّا قال الكاهنُ
واللّوحُ الناشفُ،
يكْشِفُ بعضَ حكاياتِ المَلكِ
ووَحْشِ العاهرةِ القادرةِ على إرجاعِ الشجرِ،
ليصبحَ بعد الجيمِ حليباً،
يدعو المُدُنَ لِعِيدِ عَدَالَتِها العصماء.
وقد تُعجِبهُ الحَبْكةُ؛
إنّ خُرافاتِ الولدِ المعطوبِ، وإخْفاقَ الناموسِ، وكاساتِ بناتِ الرُّسُلِ، ونومَ الأمْلاحِ على الفخذينِ، وأحمالَ البنتِ المخمورةِ..
لا تكفي لِيُقَهْقِهَ هذا العرفانيُّ
اللمّاحُ
المَشّاءُ..
والثالثُ في كَوكبهِ السابحِ،
لا يتذكّرُ ما كان من الذَّرِّ قديماً،
حيث تحَلّلَ مع خشبِ التابوتِ
وعادَ إلى دُنياهُ غريباً، ثانيةً،
دَمُهُ الملعونُ يُضيءُ الكهفَ،
ويُوقِدُ ما شاءَ مِن النّايِ،
تُراوِدهُ الغزلانُ،
وتَعشقُه الأرملةُ البِكْرُ،
ويبحثُ عن غَوْثِ المِعْراجِ النبويِّ،
لقد كانَ مع الأبْدالِ
الأبرارِ
الأوتادِ
النقباءِ..
وسوفَ يكونُ القُطْبَ،
وحولَ مَجامِرِهِ الأنوارُ،
وأوردةُ التّعْزيمِ
فيصعدُ بالآياتِ إلى الجَنّاتِ،
ويأخذُ هالتَهُ الفَوَّاحةَ،
ويكونُ كما شاء النونُ
وكافُ الأمْرِ،
ولا يَفقِدُ ما كان بضَعْفِ الميمِ
وثوبِ التاء.
وما ظَلَمَ.. اقتَصدَ قليلاً في الشكِّ
فَهذي الخِرْقَةُ وكراماتُ الشيخِ
يُدَنِّسُها النَّومُ!
تَناسَخَ لِبُروزٍ ونُذورٍ
وصُعودٍ لِلْحَضْرَةِ،
أبْطَلَ فِعْلَ الحَرْقِ وفِعْلَ الطّعْنِ،
ورَكَّبَ أجنحةً للظَّهْرِ،
وظلَّ ثلاثَ ليالٍ تحتَ الشمسِ
هنالك تَغْسلهُ الشينُ الرّمْضاءُ،
ليَرْجِعَ مثل الدالِ إلى القُرّاء.
ويقطفُ أزهارَ المجنونةِ،
ويقولُ لأشجارِ المئذنةِ ارتفعي
بالصوتِ
إلى نافذةِ المعراجِ،
ويكتبُ أجملَ ما كتبَ الأحبابُ
لأسْرابِ السّروِ؛ انتصبي
في أرضِ الإسراءِ،
وكوني المِحْرابَ
وسيّدةَ الناقوسِ،
فهذا العيدُ مراجيحُ الأطفالِ
وطاووسُ المَهْدِ
ورِيقُ الترياقِ النَبَويِّ
ودعوةُ فاطمةَ الزّهراء.
والرّابعُ ما زال النّرْجِسُ في صَفْحتهِ الجبليّةِ،
يُغْريهِ لأنْ يَخْطرَ في بَالِ الحَقلِ،
وليس لهُ أنْ يَتَضَرّعَ..
فَلَقَد جَفّ الحَلْقُ مِن العَطشِ،
وأنْسَتْهُ الذّاتُ المغرورةُ قافَ اللهِ
وَطَاءَ النّفْسِ،
ولم يبقَ سوى أنْ يرجعَ للضّادِ،
ليعرفَ أين تكونُ الخُطوَةُ
بين الواوِ وبين الهاء.
نُبوءَتُهُ الشِعرُ
وما يحفظُه النِسْيانُ مِن القَوْلِ،
ولم يُدركْ أنّ الإيقاعَ سِياجٌ،
والأحرفَ شوكٌ أو ثمرٌ،
والكلماتِ تُدَبِّجُها الصَرخاتُ
أو الموتُ على زَغَبِ الصّادِ،
أو البرعمُ إذْ يَشْهقُ مِن هَوْلِ الجِيمِ؛
جَرادٌ في الجَرّةِ،
وجحيمٌ في الجَنّةِ،
وجُنونٌ في الجُرْحِ،
وثلجٌ يلْهجُ مثل الجَمْرِ
ولامٌ للمَجْذوبِ الثاء.
ويصحو المَمْسوسُ
من الرّعدِ القاصفِ،
كان يُشَرِّعُ شُبّاكَ السَّهَرِ،
ولم يُغْلقْ نافذةَ الغيثِ،
فجاءَتْهُ العاصفةُ البَرْقيّةُ..
هذا السَادِرُ يُدْرِكَ أنّ كتابَ الغينِ طلاسمُ
يعرفها الذّاهبُ في تِبْرِ الذّالِ،
ولا تُذْهِلُهُ الذالُ الذّهَبيّةُ،
ويُفَكّكُ ما التَبَسَ مِن الأصَداءِ
وما أَكَلَتْهُ الأَرْضَةُ،
ويُجَلِّي بالكُحْلِ الأحمرِ آفاقَ الصوتِ المتعالي
في الأسماءِ الحُسنى،
ولها يسْجُدُ ما في البّرِ وما في البحرِ،
وما كان بكلِّ الأكوانِ
من الألفِ الفوّاحةِ حتى الكَسْرِ
المَجْبورِ بِلَفْظِ الياء.
فسبحانَ المَلكِ
القدّوسِ
الأوّلِ
والآخِرِ
والبادئِ
والنافعِ
والغافرِ..
والسِينُ لساني
والباءُ بياني
والحاءُ الحائرةُ الحَوراء.
والخامسُ ذو خَطّينِ من الدّمْعِ
المحفورِ على الخدّين،
يسيرُ على مَهَلٍ، في النَّومِ،
ويحملُ أيتامَ المفجوعينَ مِن الحَرْبِ
المُمتدةِ من قابيلَ إلى هابيلَ،
ويَخْذِلُهُ السّرْجُ،
وأجراسٌ رانَ عليها الصَمْتُ،
وصوتٌ خلفَ السورِ المَهدومِ يَنُوسُ،
ورايتُهُ المَشْروخَةُ في الوَحْلِ ..
يَبابٌ يحْتَلُّ الحقلَ،
ونَحْلٌ يَتركُ أزهارَ الوَجعِ،
يلفُّ
يدورُ
يَدفُّ
يَطُوفُ..
يموتُ هَباءً في التِّيجانِ،
وشيءٌ مثل السّينِ السيفِ
بِوَجْهِ الدّائِرةِ البيضاء.
صغيراً كان..
وهاءُ الهِجْرةِ في الأسبابِ.
مضى للشرقِ..
من الباءِ إلى الجيمِ،
وإحداهُنَّ تُحاولُ وَضْعَ صغيرَتها،
فاشتدّ مخاضُ مغارتِها،
واتّفقَ بأنْ ماتت بعدَ صراخِ ولادتِها..
نَزفَتْ..
وانتبهتْ أنّ الطفلةَ سَوفَ تُهاجرُ سبعينَ خريفاً،
أو أنَّ الأحفادَ المنظورينَ سيأتونَ
تِباعاً نحوَ النَطْعِ..
هنالك أدْرَكَ أنّ المحرَقةَ شِفاءٌ للنارِ..
فلا بُدَّ من الشجرِ،
ورَسْمِ الشّارةِ فوقَ الدّارِ،
ولا بُدّ من العَودةِ للمنديلِ الرّاقصِ
في أفراحِ الثّاكلِ،
والطيرُ على الشُّرفاتِ يُرَفْرفُ
مثل قميصِ الغارِ،
وتَهْجِسُ رُوحُ البِذْرةِ تحتَ الصخرةِ،
في الألوانِ وفي الحيطانِ
وقبلَ الدالِ وقبلَ الميمِ
وبعدَ الحاءِ وبعدَ الراء.
يشربُ نَعناعاً يقْطِفُهُ،
فيرى العصفورةَ كاملةَ الزّينةِ،
تتهيّأُ للشّفْرةِ فوقَ حريرٍ جَعّدَهُ العِطْرُ
ولبَّدَهُ العَرَقُ،
فيمضي في المَشْهَدِ
حتى تنْتَحبَ الأحلامُ،
ويغفو، فيرى ما يخفقُ، ثانيةً،
يتلَمّظُ بالفِضّةِ،
ويعودُ إلى الكَسَلِ،
فَيا سُبحانَ النونِ المَشْمولةِ مثلَ الشمسِ،
ويا سبحانَ القَمرِ المبعوثِ لأرضِ الضادِ، تماماً
مثل الحاءِ وحرفِ الباء.
ويصحو مثلَ المُنْتصرِ الأَوّابِ،
فينسى ما جَمحَ من الخيلِ،
وما يُلْهِبُ أوتادَ الظَهْرِ،
ويدركُ بعدَ بياضِ الرّأسِ
بأنَّ العُمْرَ خيوطٌ أتْقَنها النَسّاجُ،
لتصبحَ مِشْنقةَ الغرباءِ.
يضيعُ الوَزْنُ..
ويبقى الشّاعرُ أجرأَ مِن مُوسيقى العُرْسِ
وأكبرَ من جيم الغَنّاء.
والسادسُ يعلو نَوْرَسَهُ البحريَّ،
ويَنْدهُ في الغيمِ أن اذْهَبْ
لأراكَ على اللّوحةِ بُرْجاً،
أو طفلاً،
أو سيّدةً تتفتّحُ للبستانِ،
وتمنعُ أحْزِمَةَ الشفقِ من السَطْوِ
على العَتَباتِ،
وتقْطُرُ غَيْثاً مثل شآبيبِ الشّهدِ،
فَتَنْقَلِبُ القافُ بِسِحْرِ فَرادَتِها الشقراءِ
لأُنثى وَشَقٍ، تنظُرُ حولَ مفاتِنها المصقولةِ،
وتُزَجِّجُ حقلَ فَراشَتِها الوثنيَّةِ..
تغفو عندَ وصولِ الحاءِ،
وتُمْعنُ في دِهْليزِ الطّاء.
ويتركُ أضواءَ المَحْفَلِ،
ويثوبُ مع الشحرورِ إلى الشُّباكِ،
يرى لبلابَ هدوءٍ، يصعدُ
نحو عريشتِهُ المملؤةِ بالحَجَرِ المنقوشِ
لأدْراجِ الظِلِّ،
فينْسى بعضَ الدّمعِ،
ويَطْفَحُ..
وَيَخِفُّ مع الصَمْتِ..
هنالكَ، قال: سأخْلَعُ دُرّاعةَ أيامي الصعبةِ،
وأُغَسِّلُ صدري بالوردِ المُتَفَجِّرِ،
وأَمدُّ ذراعي لتنامَ على كتفي،
ونذوبُ قليلاً،
كي يَدْعَكَ كَفّي قِرْبَتَها الّلبنيّةَ،
أو أُخْرِجَ كلَّ الأفْراسِ مِن النَّهرِ..
فَتنفضُ سُكَّرَها!
ويغيبُ.. يعودُ،
وشبّاكُ البستانِ النّاعِسِ يكسرُ ضُوءَ
العَصْرِ السّاحرِ،
قبلَ أصَيلٍ يمشي بالمَغْربِ،
أو يَسْكبُ حِبْرَ الليلِ على المَشْهدِ!
إنَّ المُتَبَصِّرَ بالرّوعةِ والحُسْنِ سيشْهدُ
أنّ نَهارَ الرّاءِ غموضٌ شعريٌ،
والليلَ وضوحٌ لِلسَّرْدِ..
إذا ما لفّ الشَّبَحُ المَذْعورُ على
أغصان الباء.
وفي السّاحلِ زَهْرُ الليمونِ سيبقى..
حتى يبلغَ أقصى ما قال العَرّافُ؛
هنالك فَرَسٌ وُلِدَت من أثوابِ الموجِ
ستصهلُ في ناسُوتِ الخَلْقِ
وتركضُ في أطلالِ الطاءِ،
فتصحو الأعياد الغرّاء.
وهذا آخرُ أشْباهي القدماءِ،
له نَخْلَتهُ المذبوحةُ ورؤى المنْغَلِقِ،
أو استغراقُ السيفِ،
وشَطْحةُ مَنْ غابَ وأسْقى البُرْعُمَ
قهوتَه السمراءَ،
وما عادَ من الحَوْضِ..
سيقطفُ نجمتَهُ المولودةَ في المهدِ،
ويلعبُ معها،
ويُغَمْغمُ بالضِّحْكَةِ،
أو يَبْلُغُ مَن رَكِبَ الحِكْمةَ والحَرْفَ السّاري،
يسمعُ قَوْلَ الشيخِ ويُدْركُ:
مَن ليس بآتٍ أقربُ مِن نَبْضِ السّاعدِ.
يُحْيي الجسدَ المندثرَ بفعلِ تباريحِ العشْقِ،
ويعرفُ ما في الطَوْطَمِ مِن لحمٍ ذابَ
أو انْسَرَبَ ببطنِ الأرضِ،
ولكنَّ الصوتَ الساعي للوَصْلِ سَيُنْهِكُه التمثالُ..
تضرّعَ بطقوسٍ ساذجةٍ،
راقَصَ قُطعانَ البيدِ،
وردّدَ صلواتِ الأبوينِ
فَذابَ المعدنُ من خِشْيَتهِ المبلولةِ،
إذْ أَمْعنَ في الأسوارِ العاليةِ
ليبلغَ أكواخَ الحسراتِ،
وقد يبلغُ جُلْجُلةَ الرَّقْصةِ،
أو يعطي الناسَ شِراعَ الفَرحِ،
وينظرُ مِن مِشْطِ مُساواةِ الأشياءِ..
ونادى الحُبَّ،
وما كان حِجابٌ بين العينينِ
لِيُقصيَهُ..
وقد يجدُ العطشَ مجازاً للألَمِ..
فَيَرمي القُفْطانَ،
ويُلقي الوردةَ،
ويمدُّ يديهِ ثلاثَ سنينَ،
ويسألُ عن خُبْزٍ أو ماءٍ،
كي يَلِجَ الظُلمةَ.
والخِرْقةُ كفنُ السّالكِ،
بالكاساتِ المُتْرَعَةِ..
ويصبرُ،
يرضى،
يرجو..
سبعون حجاباً بين النورِ وبين الظُلْمةِ،
تَفْصِلُ آدمَ عن خالقهِ..
هل يصحو سكرانُ الحَقِّ؟
وهل مِن زَنٍّ يطلعُ في أرضٍ،
يتقابَلُ فيها الضدّانِ؟
الأضداد ستُفْسِدُ أو تُشْغِلُ
معها السالكَ سفراً
ووصولاً
ومُجاهَدَةً..
ولن تحمِلَهُ الطرقاتُ إلى الإحسانِ
أو الفيضِ
أو الجَذْبَةِ..
كيف له أن يبلغَ أحوالَ العتباتِ،
مع الشوْقِ أو الأُنْسِ أو القُرْبِ!
هي الجيمُ رجاءُ الخاشعِ كي يصلَ الأبوابَ..
وكان الخاشعُ مع عَبَقِ الندِّ
وريحِ الصنْدَلِ،
يفتحُ جُرْحَاً بصخورِ الغابةِ، ويقول:
بقلبي أنتِ صلاةٌ دائمةٌ!
يبكي مَن لَجّوا في النّومِ،
فيوقِظُ مَن ناموا، ونسوا أنْ يأتوا
لحبيبٍ، بالهاتفِ والحرفِ الحسيِّ،
وما جاءَ الرُّسُلَ بأحلامِ الليلِ،
ليكتملَ الصوفُ بما رفعوا
مِن ألفِ الدعوةِ أو راءِ الركعةِ.
قد تخرجُ عينُ الرَّاعي للطيرِ
وروحِ القربانِ،
إلى التمثالِ المنحوتِ، لترجحَ مِضْغَتُهُ
إنْ وضعوا الرِّيشةَ في كفِّ الميزانِ.
هو النائمُ تحتَ الأهرامِ بِآنيَةِ الذَّهبِ
وحِكْمةِ أبوابِ الأسوارِ ليرفعَها الفتيانُ،
وتلمعُ أثداءُ الثاءِ من الماءِ،
وتحفرُ نيرانُ الشَغَفِ مزاميرَ الَملكِ،
وتنقشُ فوقَ هواءِ الحيطانِ حروفَ الإيمانِ،
وما ثَمِلوا مِن شمسٍ تمتصُّ رحيقَ القلبِ،
فَثَمّةَ نورٌ مستورٌ يتعالى في الصدرِ،
ليرضى الأسلافُ
ويكتملَ الوَرعُ،
قُبَيلَ حريقِ المُدنِ الباذخةِ..
وكانت فاكهةُ الفقراءِ تصاويرَ النّحْتِ
وطَقْسَ الكهنوتِ!
ليرقصَ أطفالٌ ذابوا،
وتُدَوِّمَ أردافٌ أسرابَ حمامٍ،
يقْذِفْنَ الرُّمّانَ،
ويبكينَ مِن العطشِ البَرّيّ.
وهل جاوزَ حدَّ العشقِ؟
سيحفَظُ لابنِ الفارضِ تاءَ الإيقاعِ الدُّرّيّ،
وينسى عاقبةَ القتلِ لِمَنْ أثْخَنَ،
أو أطبَقَ فوق بلاد يقتلها الخمرُ..
سترجِعُ إنْ خَرجتْ مِن أقنعةِ الحالمِ،
أو حفظتْ؛ ما لا يُحْمَلُ أكثرُ مما يُحْمَلُ.
مَنْ يبتَهِلُ لهُ الأحلامُ الذهبيةُ
وحديدٌ يرتجفُ إذا نُوديَ!
فيُثيرُ مواجيدَ الشَطَحاتِ،
ويُطْفِئُ ما احترق من الشّغَفِ
أو الودِّ
أو العِشقِ،
وهذي آخرُ ما كان من الوَصْلِ
أو القُرْبِ،
وفيها يُنْكِرَ مَن عَرفَ المعروفَ،
فلا عارفَ أو معروفَ،
ولا عاشقَ أو معشوقَ..
العشقُ هو الباقي الدائمُ حتى
يُطفئَ نوُرُكَ ناري.
المتبتلُ يصعَدُ،
يكرزُ بعصاه إلى الغرباءِ المرضى،
يتوسّلُ بالدمعِ،
يُديرُ الخَدَّ الأيمنَ بعدَ الأيسرِ..
ويحبُّ الأعداء.
اهتزّت أرضُ الصّلْبِ الوهميِّ،
وما زال يهوذا بوجوهِ الباطشِ
والقاتلِ
والفاسدِ،
ما زالت أرضُ الشّعراءِ فضاءً للعدلِ
وللقسطاسِ،
وليس لها أن تلتفتَ إلى الأسيادِ
المأجورينَ الحشّاشينَ
ومَن يسرقُ أحجارَ الكعبةِ!
للشِّعرِ شرودٌ وغيابٌ،
والنثرُ مقاماتُ الأرضِ،
وتحتَ القُبّةِ زنّارٌ
ليكونَ سلاماً مُنْصَهراً في الوديانِ،
ويبقى الشغفُ
الإغراءُ
الإغواءُ
وتبقى في الإشراقِ الهاء.
والسابعُ؛
مَنْ جاءَ مع المَغْرِبِ في زَخِّ الغيثِ،
وكان رأى نورَ ملائكةٍ وَرَدتْ
تحملُ قنديلَ الشِّعرِ أو النثرِ
أو الفَلَتانِ الحُرِّ من الأشكالِ،
وصَبّتْهُ حليباً في الثدي،
وقالت نحن الأزرارُ البيضاءُ
بأثوابِ الطاعاتِ،
نُصَلّي،
ونصومُ الدّهرَ،
ولا نعشقُ مثلكَ أحمالَ الصيفِ..
أنا الألفُ السينُ الباءُ الصادُ الطاءُ النونُ،
الآتي من نَسْلِ إِمامِ التوّابينَ،
حفيدِ المِزْواجِ المِطْلاقِ،
الحافظِ لكتابِ اللهِ،
الماشي مثل الشَجرِ المسْحورِ،
وأعرفُ أُمّي الأُولى،
مَنْ تَذرفُ عينيها للعميانِ،
ولا تأكلُ أو تشربُ إلاّ
حين تعودُ البيّاراتُ؛
يكونُ الليمونُ المغسولُ قواريرَ الطّيبِ
المنعوفِ على جسدٍ،
لم تجدِ الشّينُ سبيلاً
كي تخدشَ وردتَهُ الحمراءَ،
فكان أبي، سامحه اللهُ، يجيءُ
بِسُلَّمهِ الخشبيِ ويصعدُ للسطحِ،
ليعرفَ كيف تُسافِدُهُ النجماتُ،
ليرجعَ أو يشربَ من شَهَقاتِ المرأةِ
ما قد يُغْرِقَ سَرْوَتَه المبذولةَ،
ويرى أُمّيَ فوقَ نمارِقِها تَبْكيهِ،
وتعرفُ أنّ الفَحْلَ يتوهُ إذا انغلقَ البابُ،
وتبقى في أحشاءِ الهاء.
ولي أصحابٌ للسِّحْرِ الأخّاذِ؛
الأوّلُ مثلُ الرَّيْحانةِ في الليلِ،
رقيقٌ،
ذو ألفِ جَناحٍ للفردوسِ
وقلبٍ من آهاتِ الماسِ
ودمعِ الحاءْ..
الثاني مَن يكْرُزُ في العتَماتِ،
ونادى: الطوفانُ قريبٌ..
خلفَ التلّةِ، لا تنتظروا..
القاتلُ في ثوبِ الحُرّاسِ
وسيفُ الغَدْرِ وراء الرّاء..
والثالثُ أمٌّ وضَعَتْ شمساً أُخرى،
يأخُذُ منْسَأَةَ الجِنّيِّ،
ويزْهدُ في لؤلؤةِ الناسِ
ويشربُ من إبريقِ الباءْ..
والرابعُ مِن وَهَجِ الزيتونِ،
أميرٌ غادرهُ الفُرسانُ،
سيبكي لو صمتَ الأرغولُ،
ويكسِرُ بلّورَ المرآةِ،
ويعرفُ أزرارَ العذراءْ،
والخامسُ والسادسُ،
عاشوا.. أو ماتوا
أو كانوا حُمْرةَ أشجانِ الحنّاء.
***
وكنتُ رأيتُ شياطينَ الكونِ
الضاحكةَ بِقَرْنَيْنِ من العاجِ المنْخورِ،
ابتسم الأكبرُ، ورمى الفاكهةَ الممنوعةَ،
ثمّ دعاني لِخوانٍ مسمومٍ،
فرفضتُ.. فألْحَفَ في الدّعْوةِ،
قلتُ: انصرفوا عنّي..
قال: أنا وحدي!
يقتلُني الضّجَرُ، ولا صاحبَ لي،
وأعيش طويلاً مع نِبْلي القاتلِ،
أمّا أنتَ فقد تحيا سبعينَ ثمانينَ،
تُلَوِّنُ أشياءَكَ
وتُجَمِّلُ أحزانَكَ
وتحِيلُ حياتَكَ مثل الطَيْفِ،
بديعاً أنتَ..
فَخُذْني كي أَصْحَبَكَ إلى النبْعِ الخالدِ والشهوةِ،
سأجوبُ الغابةَ،
وأُدَجِّنُ أنيابَ الوَحْشِ،
وأمْلِكُ مفتاحَ النعمةِ،
قلتُ: النقمةُ ما تملكُ والحرفُ الأسودُ،
لم يأتِ على شَفَةٍ إلاّ أهلكَها
ورماها في وَيْلِ الجيمِ
وقَعْرِ المحرقةِ السوداء.
وكيفَ تَظنُّ بأنّ النارَ تفوقُ الطّينَ؟
أراكَ من النارِ المَلْهوبَةِ،
وأراني من نُورِ العِزَّةِ.
ضوءٌ دُرّيٌّ روحي،
والكِبْرُ المُتَشاوِفُ روحُ دُخانِكَ
وعجاجُ خطاياكَ البغضاء.
فأنا البَرّيُّ المرصوفُ على خطواتِ الطّيرِ،
وفي الأَعْمِدةِ البلّورِ،
لتأخذَني الأصداءُ إلى الغاباتِ،
ومَنْ أَلْقَتْهُ الغانيةُ، شتاءً، في الفجرِ
إلى الطرقاتِ،
فألْبَسَني الزلزالُ ملابسَه المجنونةَ،
فارتبك الحَرْفان..
أنا الألفُ المكسورةُ إنْ مَدّتْ إحداهُنَّ
ضفائرَها الأنهارَ،
الهائمُ بين سفوحِ النّهدِ الهاجعِ
مثل القَنْطرةِ النّونِ،
أنا الميمُ الذائبةُ على قرميدِ العسلِ،
بساعاتِ غروبِ الشمسِ،
وعند شروقِ جدائلِ أيامي في الرّاءِ.
أنا الألفُ الممدودةُ مثل مسَلّاتِ الفرعونِ
المُتَحوّلِ من طفلٍ يلعبُ في النّهرِ
إلى آلهةٍ تأكلُ إخوتَها الفقراءَ،
أنا الضدُّ السريُّ لأبناءِ الحِكْمةِ
كي أمْلكَ حِكْمتيَ الرّعناءَ..
جَمعتُ جذوعَ الأشجارِ
وقلتُ لها: انتفضي في وجهِ الطوفانِ،
فجاءت عَرْشَاً للشطآنِ
وتاجاً في إيوانِ الباء.
***
أنا العاشقُ إن شِئْتَ تنادي: يا عاشقُ!
جَلْجَلْتُ دهاليزَ الزمنِ الغابِرِ،
وأقمتُ على منبرِ نورٍ بالصُّحْبَةِ..
كنّا أحباباَ في اللّهِ،
ولم نأْبَه لرجالٍ خرجوا للَّدنِّ الليليِّ،
ولم يصلوا للسُّكْرِ
وناموا دون غطاءٍ،
فانتبذوا المَشْرَبَ
واغتبقوا بالعنقودِ المعصورِ من الصَّهْدِ،
وغابوا عن دائرة الهاء.
أنا الصامتُ أتحدَّثُ بالكلماتِ المكتوبةِ،
ونشيجي أنْشُدُهُ بالدَّمعِ،
وأركبُ طائرةَ الحَلَقاتِ،
وأذهبُ في الَمدْحِ..
أنا عبدُكَ يا رَبَّ الناسِ،
أَعِنّي كي أُغلقَ أبوابي المُشْرعَةَ
على الخَنّاسِ الَوسْواسِ،
وأصفو بين يديْ قُدْرَتكَ الواسعةِ،
وأسْجُدُ،
لا شيءَ سوى الخشْيَةِ،
وَبُروجِ الأمواجِ الهانئةِ الموّارةِ حولَ ثمانيةٍ..
يا ليتَ ليَ القوّةَ كي أحملَ بعضاً من عَرْشِكَ
فيظلّلني النورُ الأبديُّ،
وألْهَجُ بالحَمْدِ وبالعرفانِ،
وأبقى في بَهْوِ الشَرفِ الأسمى!
يا ربَّ الكونِ، أنا الضائعُ
حتى أجدَ الدّربَ المُوصِلَ،
والتائهُ حتى تلقُفَني الرّاءُ بكفيّكَ،
وإنّي الأشقى حتى تدركَني الدّعواتُ..
وإنّي الخُسْرانُ الكاملُ دونَ تلافيفِ العَفْوِ.
وكنتُ، وما زلتُ الهشَّ المكسورَ
التيّاهَ..
فخذْ بجِماعي
واحْفَظْ لي كُلّي
أمْطِرْني من فضْلِكَ
أو نورِكَ
واجْعَلْ لي مَخْرجَ صِدْقٍ
وتَلَطَّفْ بي.. سَلّمني يا واحدُ
يا مَنْ نجَّيْتَ النونَ بِبطْنِ الحوتِ
وطوَّقْتَ الغارَ بخيْطِ العينِ
وعُشِّ يماماتِ البيداء..
ويوسفَ من نَزَوات الذّئبِ..
الشافي أنتَ
وإنّي الخَطّاءُ الخَطّاءُ.
اقبَلْني في البَرِّ وفي البَحْرِ
وحين أكونُ على حَدٍّ مشحوذٍ،
خُذْني لفَضاءِ الجَنّةِ
لأُمَتِّعَ روحي بشموسٍ مُشْرقةٍ
من أنوارِ بهائِكَ،
يا مَن لا أرجو إلّاهُ
فَخُذْني من تّيهِ الدارِ إلى الفردوسِ،
لأشربَ مِن تِرْياقِ الطّاءِ رذاذَ النُقْطَةِ
فوقَ الفاء.
أنا الأوّلُ والرابعُ والسابعُ
أو ما شئتَ من السِّحَنِ الطوّافةِ
في أجرامِ الكونِ،
ومِن نُطَفِ الأزواجِ الظمآنين..
وإنّي سابعُ إخوتيَ الصوفيينَ المنْسيّينَ
وراءَ الأَسْطُرِ، حين انتبذَ الشاعرُ
أجملَ ما كتبَ من الكُفْرِ،
وعاد مع الشِّعرِ إلى اللهِ الواحدِ،
يستعطِفُ قُدْرَته المبذولةَ للعاثرِ
والسّادرِ في الضوضاء.
أولئكَ أشباهي!
مَنْ كانوا.. فارتبكوا من جسدٍ يلهثُ،
ونسوا أنّ خيالاتِ الحِبْرِ مجازٌ
يبعثُ في الشّهوةِ أجملَ ما في الناسِ مِن الشّغفِ،
وعادوا بعد عقودٍ أصداءً
تشربُ آخرَ ما ظلّ من الكأسِ،
فَنَاسوا مثل سراجِ البيتِ المتروكِ،
هنالكَ كنتُ أُصيخُ السَمْعَ لهم،
لكنّي، مِن حيث انتبهوا، آثرتُ
لأنْ أُصبحَ قَصّاصَ الليلِ
وفارِدَ قمصانِ العُشّاقِ
على الصحراء.
كَتبتُ، ومَزّقَ أوراقي العُذّالُ،
وغادرتُ النثرَ إلى الدُّفِّ
وراقصتُ النورسَ، زاوجتُ الموجَ
مع الرّملِ، وسابقْتُ الحوتَ..
وكان نبيٌّ يهجِسُ بالغُفرانِ، فقلتُ:
أنا الظالمُ نفسي، الشاهدُ
أنّ الواحدَ فَرْدٌ صَمَدٌ،
سبحانَ اللهِ القادِرِ أنْ يلفُظَ، مَنْ غاضَبَ،
مِن جَوْفِ البحرِ إلى الأوراقِ،
ويعفو عن أفعالِ السّوءِ..
إلهي إنّي الهَشُّ
النَسَّاءُ
الكافرُ بالأنعامِ
وأنتَ اللهُ الغفّارُ الحُبُّ المِعطاءُ..
وإنّي مَنْ لبسَ الخوفَ مع الجوعِ،
وراحَ إلى التّيهِ التيّاهِ، وعدتُ
فهل أجِدُ الأبوابَ المُشْرَعةَ لأدخلَ
في عينِ العودةِ أو تاءِ التوبةِ؟
هل أسألُ أم أرجو؟
إنّي الواثقُ مِن أنْ أَلِجَ العَتباتِ إلى
أرحبَ ما قد يَجِدُ الخطّاءُ من الرِّفْقِ أو العفوِ..
كبيرٌ أنتَ..
وإنّي لا شيءَ بهذا الكونِ،
ترابٌ،
لحمٌ،
روحٌ تَنْشَّقُ من الفُحْشِ،
وتسقطُ في إغواءِ الميمِ
وتغرقُ في إبْهارِ الرّاء.
وإنّي الثلجُ النارُ،
المُرُّ الحُلوُ،
الشرُّ الخيرُ،
الحُرُّ العبدُ،
الظُلْم الَعَدْلُ،
ومَنْ سارَ إلى القَصَبِ الرّنّانِ،
وفيه من السُّكَّرِ ما طاف له النَّحلُ..
اثنان أنا أو أكثرُ،
حينَ أقومُ
وحين أرومُ
وحين أعومُ
وحين أشقُّ
وحين أدقُّ
وحين أرِقُّ،
أقولُ وأنسى ما قلَتُ،
وأفعل ما أكْرَهُ أو أنبذُ،
قد أغفلُ أو أذْكُرُ أو أنْدمُ أو أجهلُ أو أعْلمُ،
ما كنتُ وما بِنْتُ،
وما صرتُ كما قلتُ،
رجعتُ وما ضِعتُ،
وَضِعْتُ وما عُدْتُ،
أنا الضدُّ وأنكرْتُ..
أنا اثنان، القطرانُ وضِرْعُ الثلجِ،
غريبٌ ضاعَ بدربِ الوَهْمِ،
اثنان أنا؛ الشوكُ العربيدُ الأشباحُ،
ووجهُ السَوسَنةِ البيضاء.
***
ولي ستةُ أشباهٍ!
ويقولُ العارِفُ: لا..
لكَ في هذا الكوكبِ سبعةُ أشباهٍ!
لا أدري إنْ كانوا في الزمنِ الغابرِ،
أم في الأرضِ.. بعيدينَ،
ولا أعرفُ أين يقيمونَ؟
أم الأشباهُ سيأتون تِباعاً في الأعوامِ القادمةِ!
أحبّ لأنْ ألتقيَ بأيٍّ منهم
كي أعرفَ نفسي،
وأُعيدَ الصوتَ الناقصَ في همسي،
وأرى أمسي،
أو أسأل أوّلَهم أو آخرَهم:
هل تُؤمنُ مثلي بالغيم وبالطّينِ؟
وهل رُحتَ وراءَ الأسئلةِ، وما زلتَ غريباً،
وترى الناسَ هواءً،
والغابةَ أشجاراً،
والشِّعرَ ضياءً؟!
سأعاتبهُ إنْ كان أضاعَ سنينَ العمرِ هباءً..
أم ما زالَ يُحبُّ رفاقَ السجنِ،
وألوانَ القوسِ!
سأدورُ بكلِّ البلدانِ أُنادي: مَنْ يشبهني؟
لا صوتَ سيأتي غيرُ الأصداءِ المنثورةِ
في الوديانِ الصمّاءِ.
سأبكي فوقَ الصخرةِ،
ويجئُ إليَّ النرجسُ، يحضنُني،
ويُقبّلُ في عينيَّ الياء،
وأكتبُ أجملَ ما كتبَ الصوفيُّ بليلِ الكشْفِ،
وأُدركُ أنّ الأشباهَ اختلفوا،
حينَ اختلفَ الآباءُ، وحرفُ الطاءِ،
وما يأكلُ أو يقرأُ في الريحِ أو الماءِ..
سيبقى الاشباهُ،
برغم تعدُّدِ ألوانِ الصورةِ،
مثلَ الأشّعارِ، ومثلَ البركانِ،
ومثلَ الطفلِ اللاهثِ خلفَ فراشاتِ الحقلِ،
أو الأضواءِ المقهورةِ في الشمسِ الليليةِ..
سيبقى كلٌّ منهم في الزَّهرِ الشتويِّ،
وفوقَ العشبِ.. حروفاً
للحاءِ وللباء ،
وللكافِ وللنونِ ،
وللتاء الصادقةِ العذراء .
نبذة عن القصيدة
المساهمات
معلومات عن المتوكل طه

المتوكل طه

فلسطين
poet-almutawakel-taha@
25
قصيدة
78
متابعين